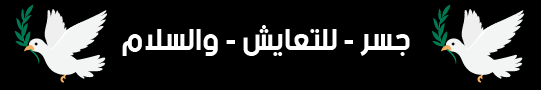تحليل .. عندما يصبح السلام صفقة سياسية : دروس من التجربة السودانية

عندما يصبح السلام صفقة سياسية : دروس من التجربة السودانية
نحو تجاوز المحاصصة وبناء دولة ما بعد الحرب(6)
تحليل:حسين سعد
تعكس الحرب بين الجيش والدعم السريع 2023م – قمة المحاصصة ،وأخطر نتائجها، حيث تجلّى فيها الصراع العاري على السلطة بين جهتين عسكريتين كانتا تتقاسمان الدولة، دون مشروع موحّد، قوات الدعم السريع، التي نشأت أصلًا لمحاربة الحركات المسلحة في دارفور قبل أن تُدمج جزئيًا في الدولة، إحتفظت بهياكل مستقلة وقوة إقتصادية خاصة، مدعومة بتوازنات سياسية وتحالفات إقليمية، والجيش، الذي يُفترض أنه العمود الفقري للدولة، دخل في صراع مباشر مع شريك الحكم، ما حدث لم يكن مجرد إنقلاب أو تمرد، بل إنفجار حتمي لمعادلة مختلّة قائمة على تقاسم النفوذ بين قوتين مسلحتين دون سلطة مدنية مستقلة ولا رؤية وطنية جامعة.
وكانت النتيجة مئات الآلاف من الضحايا، وانهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة، وهجرة جماعية، وانقسام داخلي عميق قد يمتد لسنوات، تمثّل هذه الأمثلة الواقعية مزيجًا من سوء التقدير السياسي، والانخراط في محاصصات لا تخدم إلا النخب المسلحة والسياسية، دون أدنى اعتبار لحاجة البلاد إلى الاستقرار والتنمية وبناء دولة وطنية حقيقية.
تسويات هشة ومخاطر مستدامة:
أن الممارسة الواقعية للمحاصصة في السودان سرعان ما كشفت عن أبعاد عميقة ومركبة من التأثيرات السياسية والاجتماعية، تجاوزت نطاق الترتيبات المؤقتة لتعيد تشكيل بنية الدولة والمجتمع على أسس هشّة، فعلى المستوى السياسي، أسهمت المحاصصة في تفتيت السلطة المركزية، وإضعاف المؤسسات الوطنية، وتحويل المناصب إلى أدوات للمكافأة السياسية، مما قوّض فرص بناء دولة مدنية ذات مشروع وطني جامع.
كما أدت إلى تعطيل الإصلاح المؤسسي، لأن الولاء السياسي أصبح هو معيار التعيين بدلاً من الكفاءة، وهو ما عمّق الفساد الإداري وأعاق فاعلية أجهزة الدولة، أما على المستوى الاجتماعي، فقد كرّست المحاصصة الانتماءات الإثنية والجهوية كمرجعيات للتمثيل السياسي، بدلاً من تعزيز مفهوم المواطنة المتساوية.
ونتيجة لذلك، تعزز الشعور بالغبن والتهميش بين قطاعات واسعة من الشعب، مما خلق واقعًا من الانقسام الاجتماعي، وعزز النزعة المناطقية بوصفها وسيلة للحصول على نصيب من السلطة والثروة، لا بوصفها مكونًا من مكونات التنوع الوطني، إن التحليل العام للأثر السياسي والإجتماعي للمحاصصة في السودان بعد إستعراض جذور المحاصصة وأنواعها وتجلياتها في التجربة السودانية، يبرز بوضوح أن هذا النموذج في تقاسم السلطة لم يكن مجرد خلل فني في إدارة الحكم، بل مثّل عائقًا بنيويًّا أمام بناء الدولة الوطنية الحديثة.
وقد أفرزت المحاصصة آثارًا سياسية واجتماعية عميقة، كان لها دور جوهري في إعادة إنتاج الأزمة، وتوسيع دائرة الهشاشة داخل المجتمع والدولة معًا.
شلل مؤسسات الدولة:
من الناحية السياسية أدي منهج المحاصصة إلي شلل مؤسسات الدولة وتحلل القرار الوطني ضعف الإرادة السياسية الموحدة: تفرّق الولاءات داخل السلطة أدى إلى غياب مركز قرار موحد، فتشتت السياسات، وتعطلت مشاريع الإصلاح، وتراجع الأداء الحكومي إلى أدنى مستوياته، كل طرف مشارك في المحاصصة كان يرى نفسه وصيًا على حصة بعينها، لا ممثلاً للوطن كله.
هذا أضعف ثقة الشارع في الأحزاب السياسية، والمؤسسات التنفيذية، والمجالس التشريعية، ما وسّع الفجوة بين الدولة والمواطن، وبدلاً من أن تقود المحاصصة إلى استقرار مرحلي يقود إلى انتقال ديمقراطي، أصبحت هي نفسها أداة لتمديد الأزمات، عبر إدامة الصراعات داخل السلطة وخارجها، ومن الناحية الاجتماعية تسببت المحاصصة في تفتيت النسيج الوطني وزيادة الاستقطاب تعزيز الهويات الأولية (القبلية، الجهوية، الإثنية): في ظل المحاصصة، أصبحت الانتماءات الضيقة هي المدخل للمشاركة السياسية والحصول على الموارد، ما عزز الانقسام المجتمعي وأضعف فكرة المواطنة، عندما ترتبط السلطة بالمحاصصة، تُصبح القوة هي الوسيلة الأسهل للدخول إلى المشهد السياسي.
ولذلك اتجه كثير من الشباب والمهمشين إلى العنف كطريق مختصر نحو التمثيل أو الحصول على (نصيب) من الدولة، ومع تراجع العدالة في توزيع الفرص، وغياب شعور المواطن بالتمثيل الحقيقي، تآكلت قيم الانتماء، وبدأت تظهر نزعات تفكيكية وانفصالية، كما يتجلى في بعض الخطابات الجهوية الصاعدة، خاصة في دارفور والشرق.
تفشي الفساد وتعطل التنمية:
من الناحية الاقتصادية أُخضعت مؤسسات الاقتصاد الوطني لمعادلات المحاصصة، فتم تعيين غير المؤهلين على رأس مؤسسات مالية وتجارية حساسة، مما أدى إلى سوء الإدارة، وانهيار الخدمات، وتفشي الفساد وإنعدام التخطيط الاستراتيجي لان كل فصيل داخل السلطة اهتم بإدارة ملفاته الخاصة، ما تسبب في غياب الرؤية الاقتصادية المتكاملة، وتوقف معظم برامج التنمية والإصلاح، وإنعدام الإستقرار الناتج عن تنازع مراكز القوة، وغياب الشفافية، أدى إلى عزوف المستثمرين، وتراجع ثقة الشركاء الدوليين، مما عمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومن الناحية النفسية تسبب في ترسيخ ثقافة الإحباط وفقدان الأمل تكرار الإخفاقات السياسية.
رغم التضحيات الشعبية الكبرى، أدى إلى شعور عارم بالإحباط، خصوصًا بين فئة الشباب، وغابت الثقة في إمكانية التغيير من داخل المنظومة السياسية الحالية، في ظل إنسداد الأفق، اتجه كثير من السودانيين إلى البحث عن النجاة الفردية، سواء بالهجرة، أو الانزواء، أو القبول بالأمر الواقع، ما يهدد رأس المال الاجتماعي في السودان، كل هذه المظاهر تعكس حقيقة واحدة: أن نظام المحاصصة في السودان لم يكن وسيلة لاستيعاب التنوع أو إدارة التعدد، بل أصبح وقودًا لاستمرار الأزمة وتفاقمها. ومن دون كسر هذه الحلقة المفرغة، سيبقى السودان عالقًا في دوامة انعدام الاستقرار، مهما تغيرت الحكومات أو الوجوه.
الخاتمة:
في خضم التحديات التي واجهها السودان على مدار تاريخه السياسي، تبرز اتفاقيات السلام القائمة على المحاصصة وتقسيم السلطة كأحد أبرز مظاهر فشل النخب في بناء مشروع وطني جامع. لقد أثبتت التجربة، بما لا يدع مجالًا للشك، أن هذه الإتفاقيات – رغم ما تحققه من تهدئة مؤقتة – تفتقر إلى المقومات الحقيقية للسلام المستدام، لأنها تكرّس منطق الامتيازات لا منطق الحقوق، وتعزز الانقسام لا الوحدة، وتُنتج سلطات هشة لا مؤسسات قوية، إن الطريق إلى السلام العادل والدائم في السودان لا يمكن أن يُعبّد عبر تقاسم السلطة بين من حملوا السلاح ومن تمسكوا بالسلطة، بل يجب أن يقوم على إرادة وطنية شاملة تُعيد تعريف الدولة السودانية كدولة مواطنة، وعدالة، ومؤسسات، لا كدولة توازنات مؤقتة بين نخب متصارعة.
إن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الاعتراف بأخطاء الماضي، وتجاوز نهج المحاصصة، وفتح المجال لحوار وطني جامع تُشارك فيه كل القوى الفاعلة: السياسية، والمجتمعية، والشبابية، والنسوية، من أجل بناء عقد اجتماعي جديد يعبر عن تطلعات السودانيين في السلام، والحرية، والعدالة، وعليه، فإن الدرس الأكبر الذي يجب أن يستخلصه السودانيون من هذه الاتفاقيات، هو أن السلام لا يُشترى بالمناصب، بل يُبنى بالثقة، والعدالة، والإرادة الصادقة في التغيير الجذري. فقط حينها يمكن أن تُطوى صفحة الحروب، وتُفتح صفحة جديدة في تاريخ السودان، تليق بعراقة شعبه وتضحياته الطويلة(يتبع)