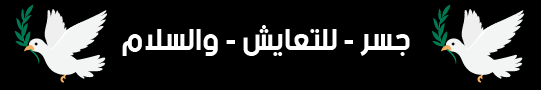عندما يغيب العقل ويعلو صوت السلاح : (3)

عندما يغيب العقل ويعلو صوت السلاح: (3)
كتب:حسين سعد
أرجع المتخصص في السلام وفض النزاعات الدكتور عباس التجاني تصاعد الخطاب العسكري مقابل تراجع دور المفكر والمثقف في إنتاج حلول للأزمة السودانية لديه عوامل متعددة ، واحدة منها المناهج التربوية والتعليمية وحتى المناهج الدراسية الجامعية وفوق الجامعية وهي بعيدة كل البعد عن التفكير النقدي بشكل جوهري والتفكير التحليلي والمنطقي والموضوعي.
وهذا جعل معظم المثقفين الذين لديهم مقدرات فكرية ومعرفية ما متصلة بالواقع حتى في دراساتهم النظرية والأكاديمية مرتبطين بجزء من التفكير النقدي العالمي بدون ما يكيفوا المعارف التي تراكمت لديهم وتوطينها في السياق السوداني ، الحاجة الثانية المؤسسة العسكرية نفسها عمرها ما قصير ، والخطاب العسكري سيطر على المشهد السياسي منذ فترة طويلة، وأصبح مهيمن.
ومنذ الاستغلال أكتر من 50 المؤسسة العسكرية قاعدة في سدة الحكم ، وكذلك المساحة في الاعلام الحكومي الاذاعة والتلفزيون كانت كبيرة للخطاب العسكري ، كذلك المثقف دوره الطليعي في التنوير غير بعيد عن هيمنة الخطاب العسكري والدليل على وجود عدد من المثقفين إنحازوا لطرفي الحرب بعضهم إنحاز مناطقيا وجهويا ولم يقدموا حلول فكرية ومعرفية.
وهذا ساهم في تصاعد خطاب الكراهية ويمارس من قبل شخصيات كان يمكن ان تقدم حلول ، وهذا فاقم من حدة الاستقطاب بسبب قضايا التنمية غير المتوازنة والصراعات الإجتماعية والاقتصادية فضلاً عن العوامل الثقافية المرتبطة بخطاب الكراهية وعوامل التنمية غير المتوازنة كل ذلك أنتج خطاب كراهية جعل الانقسام رأسياً وسط الاحزاب السياسية والنقابات وبعض المجموعات السكانية.
وأضاف التجاني (هذه قنابل موقوتة تتطلب حلول عاجلة في المستقبل وتفكير نقدي لكيفية المعالجة وماهي المناهج التي تدرس طبيعة هذه الظواهر والتعامل معها) وحول المفكر والسلام قال دكتور عباس التجاني إن بعض المفكرين السلام ليس جزء من إهتمامهم وبعضهم تماهوا مع خطاب الكراهية وتناسوا أدوارهم وإستبعد عباس إنخراط المفكرين المنحازين لطرفي الحرب في وقف الصراع الدامي في ظل المناخ الحالي الذي سيطر عليه خطاب الكراهية ومنح الخطاب العسكري مساحة أوسع للتحرك وخلق مزيد من الانقسام المجتمعي والحزبي.
وقال ان الخطاب العسكري الطاغي يحتاج الي تحليل اعلامي وثقافي وسياسي ، وحذر من إستمرارية خطاب الكراهية سيؤدي الي رواندا أخري في السودان من خلال التحشيد الواسع وتمدد خطاب الكراهية والعنصرية والاعلام الذي يصفق للحرب والموت.
الحرب كمرآة للفشل الفكري:
إلي ذلك قال الباحث والمحلل السياسي الأستاذ التجاني الحاج في حديثه مع مجلة قضايا فكرية إذا كان المعني بالبعد الفكري في معالجة أزمات السودان، هو البعد العلمي، أو على أقل تقدير، المعالجة أو التناول المستند على الموضوعية، ففرضية السؤال صحيحة، لأن ما هو شديد الوضوح أن معظم الخطابات السياسية المتحمورة حول الحرب، بعيدة كل البعد عن الموضوعية والعلمية، وهذا ما يمكن وصفه بأنه خطاب أيديولوجي فج، غرضه في نهاية المطاف ليس تناول الحرب ومسبباتها ومحاولة أيجاد معالجات لها، وإنما التبرير لها من أجل التحشيد ورص الصفوف للقتال وليس لفهم أسباب القتال.
وكما هو معروف، فالخطاب الأيديولوجي لا ينطلق من الحقائق، وإنما من القناعات وماهو غائب وليس ما هو حاضر، ويخاطب الأماني أكثر من الواقع. وبذلك فهو يشكل القوة الدافعة الرئيسية للمضي في القتال، والناس لا يموتون من أجل ما يعرفونه، وإنما من أجل ما يجهلونه، وهذه معضلة تجد أساسها في أنماط التعليم، والثقافة السائدة، والجهل بحركة ودروس التاريخ. وبالتالي فإن تسيُّد الخطاب العسكري، وتمدد خطابات الكراهية والانقسام المجتمعي، هي تحصيل حاصل لهذا الغياب الفكري والعملي في تناول القضايا.
هل يفتح الجدل الفكري أبواب السلام؟
وأضاف : التجاني الحاج صاحب كتابي :أزمة المشروع الوطني : والدولة مابعد الكلونيالية في السودان، عوامل النشوء والانحدار : عندما نقول خلافات فكرية فبالضرورة نعني خلافات أساسها علمي أو موضوعي كما أشرت في تأسيسي لذلك، فعندما يكون الخلاف فكرياً فإن الوصول للحلول يكون سهلاً، استنادا للمقولة الفلسفية الشائعة “إذا كانت المشكلة قائمة، إذن فالحل قائم”.
قد تتعدد أساليب وطرق التوصل لحلول لكنها في نهاية المطاف وصول لنفس النتيجة بطرق إثبات مختلفة فقط على خلفية ذلك عندما نقراء الخلافات حول قضايا الهوية مثال الانقسام حول العروبة والأفريقانية، فهي ليست خلافات موضوعية في واقعنا الحالي، لأنها تنطلق من أسس أيديولوجية، فمن يفترض عروبة السودان بصورة اطلاقية، لا يقول ذلك أستناداً على الحقائق الأنثروبولوجية أو السيوسيولوجية أو التاريخية، وإنما من فرضيات أيديولوجية دوغمائية موجودة في ذهنيته هو، يراها كحقيقة لا تتغير، وينطبق نفس المنطق على مسألة الأديان، فمن ينطلقون منها في تفسير الوجود يتجاهلون حقيقة جوهرية صدرها محمد أركون منذ فترة، وهي مسألة تاريخية الأديان.
وفي نهاية المطاف فإن الصراعات المسلحة ليست في واقع الأمر سوى تصادم ما بين هذه الأيديولوجيات الصماء التي تفترض صحتها هي فقط وخطأ الآخر.
السودان بين الحرب والفكر:
ويضيف المحلل السياسي التجاني الحاج :أما مسألة المشروع الوطني، فقد تكون واحدة من النماذج الساطعة للتناول الأيديولوجي لهذه القضية، وإذا كان لنا أن نعرّف المشروع الوطني كحدود وقضايا تتفق عليها الكيانات السياسية والتشكيلات الاجتماعية وتصب في صناعة تقدم أما ما أو شعب ما، فإن هذه العتبة في السودان لم نصلها بعد، والأسواء أن كل طرح يرى أنه هو المشروع الوطني الجامع والمانع، وما على الجميع الإنخراط فيه، ولا يراه كتفاعل ما بين رؤى وأطروحات متباينة، ونتاج لتعدد، بمعني، أنه لا يدعون للتطور التاريخي أن يصنع هذا الاتفاق، وأنما يحاولون فرضه، وهنا تظهر مسألة استخدام السلطة والقوة القاهرة لتطبيق ذلك، وتجربة الإسلام السياسي في السودان مثال يمشي على قدمين أمامنا لا نحتاج فيه للمقارنة مرة أخرى.(يتبع)