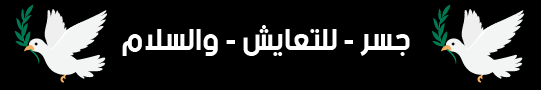الهادي الشواف : صناعة السلام المستدام في السودان .. رؤية لحل جذري لمسألة الحرب – (1)

صناعة السلام المستدام في السودان
رؤية لحل جذري لمسألة الحرب – (1)
كتب : الهادي الشواف
تتتبع هذه الرؤية في حلقات جذور النزاع المسلح في السودان، وتطرح رؤية استراتيجية لصناعة سلام مستدام لا يقتصر على وقف إطلاق النار، بل تسعة لمعالجة البنية السياسية والاجتماعية التي أنتجت الحرب، وتستند إلى تحليل الواقع السوداني، وتتبنى مقترحات عملية لبناء عقد اجتماعي جديد، وإصلاح مؤسسات الدولة، وتمكين المجتمعات المحلية.
خلفية تاريخية للنزاعات المسلحة في السودان:
بدأ النزاع في السودان تاريخيا قبيل الاستقلال بعام تقريبا، حيث اشتعلت الحرب الأهلية الأولى في العام 1955م واستمرت حتى العام 1972م، بين الحكومة المركزية في الشمال والحركات المسلحة في الجنوب، ومن أهم أسبابها حسب بعض الدراسات، الاحساس بالتهميش السياسي والاقتصادي والثقافي، وغياب التنمية في الجنوب، انتهت باتفاق أديس أبابا عام 1972م، الذي منح الجنوب حكمًا ذاتيًا مؤقتًا.
وبعد حوالي عشرة سنوات، وهي الفترة الوحيدة التي سكت فيها صوت الرصاص واستراحت فيها البنادق من العراك في السودان منذ انطلاق أول طلقة في هذا النزاع الطويل، عاد بركان الحرب ليزمجر من جديد أكثر عنفوانا، واتسعت دائرة الحرب الأهلية الثانية التي امتدد من العام 1983م وحتى توقيع اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا في العام 2005م، والتي مهّدت لانفصال جنوب السودان في 2011م، وقد سجلت مدونات الحرب بأن أهم اسبابها إلغاء اتفاق الحكم الذاتي، وفرض قوانين الشريعة، فضلا عن استمرار التهميش وغياب التنمية المتوازنة، قادها الجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة جون قرنق، خلفت أكثر من مليوني قتيل، وملايين النازحين.
الشاهد هو ان اتفاقية نيفاشا في العام 2005م، لم تصنع سلاما حقيقيا بمعالجة جذور النزع، بل ارسلت رسائل سلبية بان البندقية هي الطريق الاسهل للوصول للثروة والسلطة، فالتقطت حركات دارفور الرسالة، لتشعل فتيل ازمة نزاع جديد في العام 2003م، ظل يتنازل عبر توليد حركات مسلحة جديدة وانشقاقات متوالية حتى الان، لم توقف عجلته اتفاقيات سلام ابوجا وغيرها، لأنها لم تلامس الجرح ولم تكن علاجا ناجحا بل كانت محفزا لاستمرار الحرب، بصناعة مزيدا من المليشيات والمليشيات المضادة، ذات بعد قبلي وجهوي، ما أدى إلى جرائم واسعة النطاق، مما أُدرج النزاع ضمن أخطر الأزمات الإنسانية عالميًا، ولا يزال مستمرًا بأشكال متفرقة، ولم تتوقف مسألة الحرب في جنوب السودان دارفور، بل امتدد لتشمل جنوب كردفان والنيل الأزرق، التي اندلعت بعد انفصال الجنوب، وما زالت ذات المطالب وتستمر حتى اليوم دون تسوية شاملة ومعالجة جذرية.
مثلت ثورة ديسمبر المجيدة 2018م التي أطاحت بطغمة الثلاثين من يونيو، بارقة أمل في قطع الطريق امام دائرة الانقلابات العسكرية الجهنمية، وتمهيد الطريق امام الانتقال المدني الديمقراطي، رغم انها بدأت خطوات واسعة في سبيل ذلك، بتوقيع اتفاق سلام جوبا 2020م، وبداية وضع معالجات لعدد من القضايا الاقتصادية وغيرها، الا ان اللجنة الامنية وعناصر النظام البائد بمعاونة بعض القوى السياسية وبعض حركات سلام جوبا، قطع الطريق بانقلاب أكتوبر 2021م، ما أعاد البلاد إلى مربع الأزمة، وتوج ذلك بتفجير حرب الخامس عشر من شهر ابريل لسنة 2023م، نتيجة للصراع على السلطة الثروة بين القوات المسلحة السودانية ومن خلفها عناصر النظام البائد وقوات الدعم السريع، تمهيدا لعودة النظام البائد بالكامل، هذه الحرب أدت إلى دمار واسع في الخرطوم وبعض والولايات الأخرى، وانتهاكات فظيعة وسط المدنيين والنساء والاطفال، وتدمير شامل للبنية التحتية، وتعطيل كامل للحياة والمشاريع المنتجة، ووضعت البلاد على حافة المجاعة، ونتج عنها نزوح داخلي ولجوء خارجي غير مسبوق.
هذه الخلفية تُظهر أن النزاع في السودان ليس وليد لحظة، بل نتيجة تراكمات تاريخية من التهميش السياسي والثقافي والاجتماعي، وغياب العدالة الاجتماعية، والاختلالات التنموية، وسلسلة من الحروب المستمرة، والانقلابات العسكرية، وغيرها من التحديات اقعد بالبلاد وعقد ازمته.
تعقيدات المشهد السوداني بعد الثورة والانقلاب والحرب:
بعد ثورة ديسمبر 2018م، أُطيح بنظام طغمة الثلاثين من يونيو البائد، وشُكّلت حكومة انتقالية بشراكة ما بين القوى المدنية واللجنة الامنية العسكرية، تقاسم فيها السلطة بين المدنيين والعسكريين، صحيح ان حكومة الفترة الانتقالية كانت نتيجة طبيعية وواقعية للمشهد القائم على توازن القوة وتوازن الضعف، الا انه انتج واقع هذا هش وغير متجانس، فشل في بناء ثقة بين الطرفين، بل اتسم بالمشاكسة ووضع العقبات والكوابح والمتاريس، امام المضي قدما في تنفيذ خطط وبرامج الفترة الانتقالية، من قبل العناصر التي تكمن مصلحتها في فشل تجربة الفترة الانتقالية، وتمهيد المشهد لعودة النظام البائد، هذا الوضع الهش أدى إلى انقلاب 25 أكتوبر 2021م بقيادة الجيش، مما أعاد البلاد إلى الحكم العسكري وأشعل موجة احتجاجات جديدة، والانقلاب عمّق الاستقطاب بين القوى المدنية، وأضعف مؤسسات الفترة الانتقالية، وقاد إلى حرب الخامس عشر من ابريل 2023م.
تفجّر الصراع بين الجيش والدعم السريع ومن خلفهما حلفائهما، تحوّل إلى حرب مفتوحة، سببها الظاهر والمباشر هو خلافات على دمج الدعم السريع في الجيش، لكنها تعكس صراعًا أعمق على السلطة والثروة، وأكثر عمقا التمهيد لعودة طغمة الثلاثين من يونيو المبادة، دخول الحرب لعامها الثالث أدى إلى دمار واسع في البلاد، وقتل يرتقي لدرجة الابادة الجماعية والقتل على اساس العنصر والجهة، وعمليات نهب وسرقة واسعة، وانتهاكات فظيعة لحقوق الانسان خاصة وسط النساء والاطفال والشيوخ من عنف واغتصابات وغيرها، وتشريد ونزوح أكثر من (7) ملايين شخص داخليًا وخارجيًا، ووضع البلاد على حافة المجاعة.
وادت إلى تدمير البنية التحتية وانهيار مؤسسات الدولة، وانهار الاقتصاد، مع تفاقم التضخم، وانهيار العملة، وتوقف الإنتاج الزراعي والصناعي، وتعطّلت مؤسسات الدولة بالكامل، العدلية والقضائية، التعليم، الصحة، والخدمات الأساسية والانتاجية، وغياب سلطة مركزية موحدة أدى إلى فراغ أمني وسلطوي، وظهور سلطات محلية متنازعة، خاصة في دارفور وكردفان.
ومن ابرز تعقيدات المشهد السوداني الراهنة، التشظي الكبير وسط القوى المدنية الديمقراطية، وقوى الثورة إلى تيارات متباينة، بعضها دخل في تسويات سياسية، وبعضها رفض أي شراكة مع العسكر، واتسعت الشقة بينها بعد اندلاع الحرب، وحصل اصطفاف بسبب الموقف من الحرب، وغياب قيادة موحدة أضعف قدرة الحراك المدني على فرض أجندته، وفتح المجال أمام الردة وتدخل قوى إقليمية ودولية.
ايضا من التحديات الكبرى في المشهد الحالي تعدد المبادرات الدولية والإقليمية، مثل منبر جدة، والآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الإيقاد)، وفيما بعد الرباعية، فشلت في توحيد الأطراف أو فرض وقف دائم لإطلاق النار، حتى الان، التدخلات الإقليمية والدولية سعرت الحرب وعقدت المشهد، لأنها غالبًا ما تعكس مصالح متضاربة، مما يعقّد فرص الحل.
ومن أكبر تعقيدات المشهد ايضًا، الأزمة الإنسانية المتفاقمة، ملايين النازحين واللاجئين يعيشون في ظروف كارثية، انهيار النظام الصحي وانتشار الأوبئة، فجوة غذائية وضعت البلاد امام حافة المجاعة، انقطاع التعليم لأكثر من عامين في معظم المناطق، النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من العنف والنزوح والانتهاكات.
ومن ما زاد المشهد تعقيدا غياب الأفق السياسي الواضح، حيث لا توجد خارطة طريق واضحة ومتوافق عليها لإيقاف الحرب واحداث انتقال سياسي، لا جهة واحدة تملك شرعية كاملة لتمثيل السودان، لا جهة تمتلك ادوات ضغط للطرفين لإجبارهم على توقف الحرب، واستمرار الحرب وهذا النزيف يُهدد بتفكك الدولة ووحدتها، وتنازل مجموعات ومليشيات مسلحة متعددة وذات طابع جهوي أو قبلي يرسم واقع ومستقبل اكثر تعقيدا.
تعقيدات المشهد السوداني بعد الثورة والانقلاب والحرب الأخيرة، يُبرز التحديات البنيوية والسياسية المعقدة التي تُعيق الوصول إلى سلام مستدام وتحول مدني ديمقراطي حقيقي، هذه التعقيدات نتاج تراكمات تاريخية من التهميش، والعنف السياسي، والانقلابات العسكرية، لكنه أيضًا نتيجة مباشرة لفشل النخب في بناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة، التعقيد لا يعني الاستحالة، لكنه يتطلب رؤية جذرية، وإرادة شعبية جامعة، وتفكيكًا حقيقيًا لمنظومة العنف، وهذا لا يتأتى الا بتوحد القوى السياسية والمجتمعية واصطفافها حول خارطة طريق محل توافق واجماع، مع وجود ضغوط قوية من اطراف اقليمية ودولية.
من إدارة الأزمة إلى بناء السلام الحقيقي.. ضرورة التحول الاستراتيجي:
منذ عقود، ظل السودان يدور في حلقة مفرغة من إدارة الأزمات، حيث تُعالج النزاعات عبر اتفاقات مؤقتة، ووقف إطلاق نار هش، وتسويات فوقية لا تمس جذور الصراع، رغم أنها تُخفف من حدة العنف مؤقتًا، إلا أنها تُعيد إنتاج الأزمة في شكل جديد، وترسل رسائل سلبية لجهات اخرى فتتسع دائرة الحرب، وتُبقي البلاد رهينة لعدم الاستقرار واتساع رقعت الحرب.
والانتقال إلى بناء السلام الحقيقي يعني تجاوز منطق “الإطفاء السياسي” إلى منطق “التحول البنيوي”، فصناعة وبناء السلام لا يقتصر على إسكات صوت البنادق، بل يشمل إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس العدالة والمساواة والمواطنة دون تميز، والعمل بصورة جادة وصارمة على تفكيك منظومة العنف السياسي التي تُنتج الانقلابات العسكرية والمليشيات المسلحة، وتمكين المجتمعات المحلية من قيادة مشاريع التنمية والمصالحة المجتمعية، وإشراك النساء والشباب في صياغة مستقبل البلاد، لا في هامش المشهد.
ان السلام الحقيقي لا يُفرض من الخارج، ولا يُصاغ في غرف مغلقة، بل يُبنى عبر حوار وطني شامل، واعتراف متبادل، ونابع من تشخيص واقعي للازمة السودانية، ووضع معالجات جذرية لها، وبناء مشروع وطني جماعي يُعيد للسودانيين ثقتهم في أنفسهم وفي دولتهم، إن استمرار التعامل مع الازمة السوداني تكتيكيًا، من منظور إدارة الأزمة فقط دون تحول جذري وعميق في مقاربة المشكل السوداني، سوف يقود إلى تهديد بانهيار الدولة وتفككها، ويُطيل أمد المعاناة الإنسانية، ويُغلق نوافذ الأمل أمام الأجيال القادمة.
اولًا: معالجة جذور النزاع وليس أعراضه:
أزمة الهوية وتعدد الانتماءات في السودان:
في بلدٍ تتقاطع فيه اللغات والثقافات والانتماءات، لم تكن أزمة السودان يومًا أزمة حدود فقط، بل أزمة هوية لم تُحسم، فالدولة السودانية الحديثة وُلدت على نموذج أحادي، تجاهل التعدد العرقي والديني واللغوي، وفرض مركزية ثقافية وسياسية أفرزت التهميش والتمرد، اليوم، وبعد عقود من النزاعات والانقسامات، لم يعد ممكنًا بناء سلام مستدام دون إعادة تعريف الهوية الوطنية على أساس المواطنة المتساوية دون تميز والاعتراف بالتنوع كقوة لا كتهديد. إن السودان لا يحتاج إلى شعار جديد، بل إلى عقد اجتماعي جديد يعكس حقيقته المتعددة، ويمنح لكل سوداني مكانًا في الحكاية الجماعية.
تُعد أزمة الهوية في السودان من أبرز جذور النزاعات المتكررة التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال. فالسودان ليس كيانًا متجانسًا، بل هو فسيفساء من الأعراق، والثقافات، واللغات، والانتماءات الدينية والقبلية. غير أن الدولة السودانية الحديثة فشلت في الاعتراف بهذا التعدد كمصدر قوة، وسعت بدلًا من ذلك إلى فرض هوية أحادية، غالبًا ما ارتبطت بالمركز النيلي العربي الإسلامي، مما عمّق الإقصاء والتهميش.
- الاستعلاء الثقافي واللغوي:
فرض اللغة العربية والثقافة الإسلامية كمرجعية وحيدة، يهمّش الثقافات واللغات المحلية في دارفور، النوبة، الشرق، والجنوب سابقًا، المواطن السوداني رهين الانتماءات المتقاطعة فغالبًا ما يجد نفسه ممزقًا بين انتمائه القبلي، والجهوي، والديني، والوطني، دون وجود إطار جامع يُنظّم هذه الانتماءات في مشروع وطني مشترك، بسبب استغلال هذا التنوع من قبل البعض لتحقيق مصالح متعلقة بالسيطرة على السلطة الثروة، في حين انه يمكن ان يمثل التنوع الثقافي مصدر قوة وثراء للدولة السودانية، واللغة والثقافة العربية لديها من القدرة والمرونة على ان تكون مدخل للوحدة في اطار التنوع.
والتمييز في المواطنة وغياب المساواة في الحقوق والفرص بين المواطنين، بناءً على العرق أو الجهة أو الدين، أدى إلى شعور عميق بالظلم، وولّد حركات احتجاجية ومسلحة، كما ان تسيس الهوية، حيث استخدمت الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة الهوية والمواطنة كأداة للفرز السياسي والاجتماعي، مما غذّى الانقسامات، وأضعف الاحساس بالانتماء المواطنة.
والمعالجة الجذرية لأزمة الهوية وإعادة تعريف الهوية الوطنية، يجب أن ينطلق من المدخل المناسب وهو ان الهوية السودانية تنهض على أساس المواطنة المتساوية دون تميز، والاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي والديني، دون فرض نموذج واحد، أو اقصاء أو تهميش مجموعة اجتماعية أو ثقافية، بالإضافة إلى بناء وصناعة دستور يعكس هذا التنوع ويُقرّ بالتعدد، ويُكرّس الحقوق الثقافية واللغوية، ويمنع التمييز على أساس النوع أو الدين أو العنصر، وكل هذا لكي يتحول إلى واقع ويذهب تجاه المعالجة الجذرية، لا بد من اجراء إصلاحات عميقة في المناهج التعليمية، لتشمل تاريخ وثقافات كل الأقاليم والمكونات، وتُعزز قيم التعدد والتسامح والانتماء المشترك، والعمل على تمكين المجموعات المحلية ضمن إطار وطني، بالإضافة إلى دعم الفنون، واللغات المحلية، والموروثات الثقافية، ضمن مشروع وطني شاملًا لا يُقصي أحدًا، وتتويج ذلك بإطلاق حوار وطني ومجتمعي واسع حول الهوية يُشارك فيه المثقفون، والشباب، والنساء، والمجتمعات المحلية، لصياغة تصور مشترك ومتوافق عليه لهوية السودان المستقبلية.
السودان لا يحتاج إلى شعار جديد، بل إلى عقد اجتماعي يعكس حقيقة التنوع الغني ويحسن ادارته، بمنح كل سوداني مكانًا في الحكاية الجماعية، فالتنوع ليس تهديدًا ولا مدخلا للصراع والتنازع، بل فرصة لبناء وطن غني بتنوعه، قوي بتماسكه، عادل في انتمائه، إن أزمة الهوية ليست مجرد قضية ثقافية، بل هي مفتاح السلام، والاستقرار، والديمقراطية.
أن الحقل المعرفي المناسب لدراسة هوية أي مجتمع هو الحقل الثقافي، لان الثقافة يمكن مقاربتها علميًا ومعرفيًا، ولكن المقاربات الاخرى تقود إلى أزمة سياسية بنيوية تُغذي النزاعات، وتُضعف الدولة، وتُهدد السلام، والقول الفصل هو انه لا يمكن بناء سلام مستدام، وحل جذري للازمة السودانية، دون معالجة مسألة الهوية في حقلها الثقافي عبر مشروع وطني يعترف بالتنوع، ويُعيد تعريف الانتماء على أساس المواطنة دون تميز والعدالة الاجتماعية والمساواة.